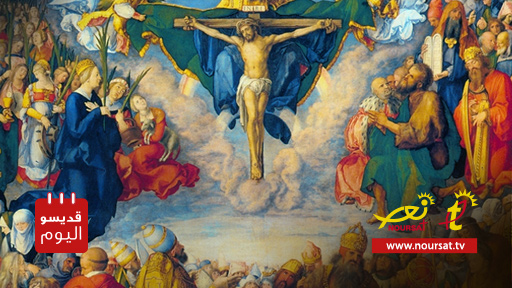قديسو اليوم : 27 آب 2015
وقد امتاز في درس الحياة الباطنية فتجنب كل ما يعكّر صفاءها. جاءته والدته يوماً لتراه، فلم يخاطبها الا من داخل قليته، اماتة لاهوائه الطبيعية.
ومن كلامه وحكمه: ان النفس تحتاج الى التواضع احتياج الجسد الى النفس. وان الناس يضعون نقائصهم وراء ظهورهم لئلا يروها، اما نقائص الغير فيضعونها امامهم. ينموالانسان بالفضيلة بمقدار حذره من محبته الذاتية وكفرانه بنفسه. من يضع لجاماً للسانه فاز بالطمأنينة والسلام. يجب ان نحب الخطأة ونشفق عليهم كي يتوبوا.
ومنحه الله صنع المعجزات فكان يشفي الناس من امراض النفس والجسد واراد احد الولاة ان يراه فلم يمكّنه من رؤيته، فحبس ابن اخته قصد ان يأتي خالهُ فيخلصه. فأتت ام الشاب تترجى اخاها ليشفق عليها ويخلص ابنها من الحبس، فأجابها احد الاخوة بلسانه:" ان بيمين ما خلف بنين". فأصبح كلامه هذا مضرب المثل. فألح الوالي عليه بان يكتفي برسالة منه ليطلق ابن اخته من الحبس. فكتب بيمين اليه يقول: ان كان مذنباً فعامله بحسب العدل وإلاّ فأطلقه، فدهش الوالي من هذا التجرد العجيب واطلق الشاب.
وكان الآباء والمتوحدون يتخذون هذا القديس مرشداً ومعلماً لهم، يقتدون بفضائله ويستنيرون بارشاداته ونصائحه الحكيمة. وكانت التقشفات والاسهار قد أنحلت جسمه فشعر بدنوّ اجله واستعدّ لملاقاة ربه بالصلوات الحارة والاشواق القلبية الى الاتحاد الدائم بالله ورقد بالرب سنة 451 م. وله من العمر ثمانون سنة قضى خمساً وستين منها ناسكاً في القفر. صلاته معنا. آمين.
القديس البار بيمين (بحسب الكنيسة الارثوذكسية)
أصل القديس بيمين من مصر. اسمه باليونانية معناه راع. في سن الخامسة عشرة انضم إلى إخوته الستة الذين كانوا يتعاطون النسك في برية شيهيت. أخوه الأكبر كان أيوب أو أنوب وأخوه الأصغر بائيسيوس. حين كان، بعد، فتياً ذهب فسأل شيخاً في شأن ثلاثة أفكار. لكنه أثناء الكلام نسي أحدها. فلما عاد إلى قلايته وتذكر، عاد للحال إلى الشيخ – والمسافة كانت طويلة – ليُطلعه على فكره. وإذ عَجب الشيخ لاهتمامه في أن يكون له قلب نقي لدى الله تنبأ له: "يا بيمين، سوف يكون اسمك معروفاً في كل مصر وستكون، بالفعل، راعياً، كاسمك، لقطيع كبير جداً. لما أغار البربر على برية شيهيت، سنة 407م، نجا الإخوة السبعة من المذبحة وانطلقوا إلى نيتريا حيث أقاموا في ترنوني التي هي اللطرانة الحالية في صعيد مصر، على ضفاف النيل. هناك ذاع صيت بيمين حتى أخذ الأتقياء يغادرون الشيوخ الذين اعتادوا عليهم إليه سؤلاً لمشورته. حين كان زائر يفد على أخيه الأنبا أيوب (أنوب) سائلاً كان يحيله على بيمين لأنه كلن يعرف أن لأخيه موهبة التعليم. لكن كان بيمين يحجم عن الكلام في حضرة أخيه الأكبر، كما أبى عليه تواضعه أن يكلم أحداً في إثر سواه من الشيوخ رغم أنه فاق الجميع.
لما درت بمعتزل السبعة أمهم طلبت وجههم فامتنعوا بإصرار، فذهبت إلى أمام الكنيسة وانتظرت قدوم الأشياخ في الاجتماع الأسبوعي. فلما رآها أولادها ارتدوا على أعقابهم للحال. ركضت في إثرهم فألقت الباب موصداً فأنّت وصاحت، فقال بيمين لأمه من الداخل: "أتؤثرين أن تبصرينا ههنا أم في الدهر الآتي؟" فأجابت: "ولكن ألست أمكم؟ ألست من أرضعكم؟ والآن سبت، أما أستطيع أن أراكم؟" فأردف: "إذا أمسكت نفسك حتى لا ترينا ههنا فسترينا هناك إلى الأبد". فانصرفت الأم التقية فرحة وهي تقول: "إذا كنت سأراكم هناك فلست أرغب في أن أراكم ههنا".
سأل الأب يوسف أخاه الأنبا بيمين عن الطريقة الأنسب للصوم فأجابه إنه يفضل أن يأكل الإنسان قليلاً جداً كل يوم ولا يشبع. أجاب يوسف: لكنك لما كنت صغيراً كنت تصوم يومين يومين في وقت من الأوقات. فأردف بيمين: صحيح، وأحياناً كنت أصوم ثلاثة أيام وأحياناً أربعة وأكثر. كل الأقدمين تقريباً مروا بهذه الخبرة، لكنهم خلصوا، في النهاية، إلى أن الأوفق للإنسان أن يأكل كل يوم قدراً ضئيلاً من الطعام، وبهذا أرشدونا إلى الطريق المأمون الميسر إلى الملكوت. بهذه الطريقة لا يسقط الإنسان في الكبرياء ولا يذل في الاعتداد بالذات.
فاجأه أحد الإخوة يوماً وهو يغسل قدميه فعثر فأجابه بيمين: لم نتعلم أن نقتل الجسد بل الأهواء. وكان يقول أيضاً: كل ما يفوق الحد يكون من إبليس.
كان الأنبا بيمين رقيقاً جداً، كله محبة، يهتم بأعمال الرحمة والمحبة. وقد قدّم لتلاميذه ذات يوم هذا المثل. قال كان لرجل ثلاثة أصدقاء. سأله الأول أن يأتي معه إلى الملك فسار به إلى منتصف الطريق. وسأله الثاني الأمر عينه وذهب به حتى بلاط القصر. أما الثالث فدخل به إلى داخل البلاط وأوقفه بين يدي الملك وتكلم عنه في كل ما يريده من الملك. فلما سأله الإخوة أن يفسِّر لهم المثل قال: الصديق الأول هو "النسك والحرمان". هذان يبلغان الإنسان منتصف الطريق لكنهما أعجز من أن يُكملاها معه. والصديق الثاني هو الطهارة. أما الثالث فهو "الحب" أو أعمال الرحمة التي تدخل بالإنسان إلى حضرة الله وتشفع فيه بدالة قوية. هذا المثل أخذه بيمين عن أحد العامة ممن جاؤوا لزيارة الرهبان. ولما ألحّ عليه القديس أن يقول له كلمة تنفعه قال له هذا المثل.
ومما قيل عن ترفقه بالخطأة أن رئيس أحد أديرة الفرما جاءه مرة مستعيناً. كان قد طرد بعض الرهبان لأنهم ينزلون إلى المدن ويفقدون روح رسالتهم. لكنه شعر بتبكيت ضمير فسأل بيمين في الأمر. قال له بيمين "أيها الأخ، هل خلعت عنك الإنسان العتيق حتى لم يبق فيك شيء البتة؟" قال: "لا! للأسف لا زلت أعاني الكثير من عبوديته". فأجابه الأنبا بيمين: "إذاً لماذا تقسو هكذا على إخوتك وأنت لا زلت تحت الآلام؟ اذهب وابحث عن ضحاياك وأحضرهم إلي". ففعل وكانوا نادمين. فقبلهم بيمين ونصحهم وأطلقهم بسلام إلى ديرهم.
ومما يُظهر محبته أيضاً أنه كان في إحدى قرى مصر كان بجواره راهب يسكن مع امرأة. فإذ درى القديس بأمره لم يوبّخه، بل لما حان وقت ولادتها أرسل مع أحد الإخوة نبيذاً، ربما كدواء، قائلاً إنّ الأخ المنكوب قد يكون في حاجة إليه في هذا اليوم. فتألم الأخ جداً وعاد إلى نفسه، ثم أتى إلى الأنبا بيمين وقدّم توبة صادقة، إذ ترك المرأة وانطلق إلى البرية وسكن في قلاية مجاورة للقديس. وكان يستشيره في كل شيء إلى أن تكمّل بنعمة الله.
لم يكن الصمت عند القديس بيمين غاية في ذاته. قال: "الصمت من أجل الله جيد كما الكلام من أجل الله جيد". من أقواله في هذا الشأن: "قد نجد إنساناً يظن أنه صامت لكنه يدين الآخرين بفكره، فمن كانت هذه شيمته فهو دائم الكلام... وآخر يتكلم من الصبح إلى المساء لكن كلامه فيه نفع للنفس. مثل هذا أجاد الصمت".
حين كان زائر يرغب في الحديث إليه في الأمور السامية كان يلزم الصمت. ولكن إذا سأله في الأهواء وفي كيفية تعافي النفس كان يجيبه بفرح. إجاباته كانت موزونة على قياس سامعيه ليجعل طريق الفضيلة لديهم سالكة.
عن الأفكار قال: كما أن الثياب الكثيرة الموضوعة في الخزانة لمدة طويلة تتهرأ، هكذا الأفكار إذا لم نسلك فيها تتلاشى مع الوقت.
وقد علم أن ثلاثة في تنقية النفس، أن يلقي المرء بنفسه أمام الله ولا يقيس نفسه ويلقي عنه كل مشيئة ذاتية. كذلك قال: بلوم النفس والصحو تنبني النفس وتتقدم إلى الكمال. حين كان يرى أخاً نائماً في الكنيسة كان يجعل رأسه على ركبتيه ليريحه. أما صحوه، من جهة نفسه، فكان صارماً فيه عالماً أن مبدأ كل الرذائل هو التشتت. وقبل أن يخرج من قلايته كان يُمضي ساعة جالساً يفحص أفكاره.
قال: الإنسان بحاجة إلى التواضع حاجته إلى نفس منخاريه. وإنه بلوم النفس الذي يجعلنا نقدّم أخانا على أنفسنا يكون لنا وصول إلى هذا التواضع الذي يسبغ علينا، في كل ظرف، راحة. من جهة نفسه كان يأنف من نفسه حتى كان يقول: في الموضع الذي يُلقى فيه الشيطان ألقي بنفسي وأجعل ذاتي دون الكائنات غير الناطقة لأني عارف أنهم دوني بلا عيب. سألوه كيف يجعل نفسه دون المجرم فقال: المجرم أخطأ مرة أما أنا فأخطئ كل يوم.
جاءه مرة، زوار ذوو رفعة من البلاد السورية ليسألوه في نقاوة القلب. لم يكن بيمين يعرف اليونانية ولما يوجد ترجمان. وإذ لاحظ ارتباك زائريه شرع يحدّثهم فجأة باليونانية قائلاً: "طبيعة المياه رخوة وطبيعة الحجر قاسية. ولكن إذا علقنا قربة فوق الحجر وتركنا الماء تنقط نقطة نقطة فإنها تخرق الحجر. هكذا الأمر بالنسبة لكلام الله. كلام الله بطبيعته كالماء رقةً وقلبنا قاس، فإن سمع الإنسان، بتواتر، كلام الله فإنه يفتح القلب على مخافة الله.
لازم بيمين البرية سبعين سنة وعاصر الآباء القديسين أرسانيوس ومكاريوس الكبير ومكاريوس الإسكندري، وتنيّح حوالي العام 460م.
وفي مثل هذا اليوم أيضاً : القديس الشهيد فانوريوس
أثناء العمل في ترميم حيطان قلعة رودس اكتشف العمّال كنيسة جميلة في حالة خراب. تحت البلاط وجدوا عدداً من الإيقونات بينها واحدة كانت في حالة سليمة تماماً, وهي تمثّل شاباً عسكرياً يحمل في يده اليمنى صليباً وفوقه سراج مضاء, وحول الإيقونة صور تمثّل اثني عشر مشهداً من استشهاده. أسقف المحلّة المدعو نيلّس تمكّن من قراءة الكتابة على صعوبتها فتبيّن أن اسم القدّيس هو "فانوريوس", ربما من كلمة يونانية تعني "أن يكتشف", "أن يظهر". هذا وقد جرت بالقدّيس فانوريوس عجائب جمّة لا سيما لجهة الكشف عن الأشياء أو الحيوانات الضائعة.
تذكار أبينا البار بمين (بحسب كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك)
إنّ الأب البار بمين، أي راعي، هو من أبناء مصر، تلك الأرض الغنيّة بالآباء المتوحّدين، وبالعلماء القديسين، وبجماهير الشهداء والمعترفين. وُلد في الرابع الأخير من القرن الرابع، ونشأ في بيت تزيّن بالتقوى وحسن العبادة، فعكف منذ حداثته على ممارسة الفضيلة وأعمال البرّ.
وكان له ستة أخوة، بعضهم أكبر منه والآخرون أصغر. فكان هو مثالاً لجميعهم بطاعته ووداعته وإسراع إلى خدمتهم كلّهم. وكانت صلاته العقلية حارة متواصلة. ومنحه الله منذ أيام الحداثة موهبة إجتذاب القلوب إليه، فكان يتسلّط عليها بحديثه العذب، ووداعته المأنوسة، ويعودها بلطفه إلى ما يريد منها من فضيلة وكمال. وكانت أميال قلبه تصبو إلى حياة الخلوة والإنفراد، وتنظر إلى الدنيا بعين الزهد والإزدراء.
فلم يكد يبلغ السن الخامسة عشرة حتى ترك بيت أبيه، وذهب ينسك في تلك القفار المصرية التي كانت آهلةً وقتئذٍ بالألوف من المتوحّدين والرهبان. واقتدى به أخوته أيضاً، فزهدوا في الدنيا وتركوا العالم، الواحد تلو الآخر، وساروا على أثر أخيهم بمين، يعيشون في البراري والأديار.
وبدأ بمين حياته النسكية بأن تتلمذ لأحد النسّاك، وشرع يمارس على يده بجدّ ونشاط أعمال النسك وفضائل النسّاك. فأخذ يشدّد على نفسه في الصوم. فكان يأكل مرةً واحدة كل يومين، ثم مرةً كل ثلاثة أيام، إلى أن صار يأكل مرةً واحدة في الأسبوع. لكنّه لمّا تقدّم في العمر ورأى أن كثرة صياماته الظاهرة تعرّضه للمجد الباطل، صار يأكل كل يومٍ ولكن شيئاً قليلاً جداً، بحيث أنّه كان يبقى جائعاً أبداً. وهكذا كان يظهر أمام سائر النسّاك كرجل لا يحفظ من أنواع الصوم إلاّ ما تأمر به القوانين. فكان بعمله هذا يرمي طريدتين بسهم واحد، لأنّه كان يميت أهواء الجسد وأهواء النفس معاً.
وما لبث بمين أن انفرد لوحده في القفار، وقام يجاهد جهاد الأبطال، ليصل إلى ما تصبو إليه نفسه من الكمال. فبقي حياته كلّها مسلّماً أمره لله في قواه العقلية والجسدية، لا يكترث لشقاء ولا يطرب لهناء، ولا يطالب بحق من حقوقه، ولا يحسب حساباً لنفسه كأنّه لم يعد من أهل الدنيا.
ورتّب بمين إستعمال أوقاته ترتيباً محكّماً لئلاّ يضيع ذرةً منها. فكان بعد صلاة الصبح يشتغل بيديه إلى الظهر. ثم يعكف على القراءة الروحيّة إلى العصر. ثم يقوم فيجمع ما يلزمه من الأعشاب لغذائه، إلى أن يحين وقت الصلاة الغروب. أمّا ليله فكان يقضي أربع ساعات منه في الصلاة العقلية وتلاوة المزامير. أمّا شغله، فكان صنع السلال، نظير شغل سائر النسّاك. فكان يبيعها وينفق على نفسه من ثمنها، ويتصدّق بالباقي على الفقراء.
وامتاز الأب يمين طول حياته بفضيلتي التواضع ومحبّة القريب، ترافقهما وداعة وصفاء مزاج عجيب. فلم تكن شدائد الحياة، مهما ثقلت وطأتها عليه، للتغلّب على هدوئه وسكينته، أو لتعكّر سلام قلبه. كان متّحداً بالله، وكان يرى يد الله في كل دقائق الحياة. فكانت أيامه تسيل بهدوء وطمأنينة.
أمّا فضيلة محبّة القريب، فكانت في رأس أعماله وحياته. فكان كلاً للكل. فلم يكن يأتيه حزين إلاّ عزاه، ولا موجوع إلاّ آساه. وكان حليماً مع الخطأة، عطوفاً على المذنبين وصغار النفوس والمقصّرين.
وكافأ الرب تلك الفضيلة السامية بصنع العجائب. فصارت الناس تأتيه من كل الأنحاء، حاملةً إليه أسقام النفوس والأجساد. فكان كلامه تعزية للحزين، وصلاته شفاء للسقيم.
وكان ينظر إلى حال كلٍ من زوّاره ويرشده إلى ما به صلاحه وخيره. وأتاه يوماً راهب يستشيره في أمر حياته، لأنّه لم يكن يتعاطى شيئاً من أعمال العبادة، بل كان يخصّص أوقاته كلّها لفلاحة البساتين، ويوزّع ما يجنيه من عمله هذا على الفقراء.
وأتته أمّه يوماً تعوده، فلم يرضَ أن يقبلها، لأن زيارتها له لم تكن لغرضٍ ما سوى إرضاء شهوة قلبها الوالدي من النظر إليه والجلوس بقربه. أمّا الأب بمين فلم يكن ذاك الراهب الذي يسمح لنفسه بلذةٍ أرضية، مهما كانت شرعية، لذلك لم يرضَ أن يقبلها. فانطرحت عند بابه وأخذت تتضرّع إليه بدموع أن يأذن لها في زيارته.
وأتته شقيقته أيضاً مرةً تطلب إليه أن يتوسط لدى الحاكم ليعفي عن إبنها ويطلقه من السجن، وأرسلت تقول له مع أحد تلاميذه، أن الحاكم وعدها بأن يطلق ذلك الشاب إن كان هو يذهب إليه ويشفع فيه. فبعث إليها أخوها يقول لها: أن بمين له بنون ينقذهم من السجون. كان ذاك الحاكم الفضولي قد ظن أنّه بتلك الحيلة يظفر بزيارة الأب بمين وبرؤيته، فطاش سهمه.
وكان البار بمين يستقي تلك المياه الخلاصية الحكيمة، التي تروي قلبه وتفيض إلى قلوب الغير، من الصلاة العقلية المتواصلة، ومن التأملات اليومية، ومن القراءات الروحية التي كان يمارسها بإنتظام كل يوم.
وكان يرى أن الطاعة والتجرّد عن الإرادة الذاتية هما خير الوسائل للبلوغ إلى الكمال. وكان يدعو إلى الصمت ويأمر به، لكي يستطيع الراهب أن يتفرّغ بهدوء لأعمال الحياة الروحيّة.
إن الله إفتقد ذلك الناسك الشغوف بحياة الصمت والصلاة والإنفراد بهجمات متكرّرة من البرابرة. فإنّ تلك القبائل المتوحّشة كثيراً ما كانت تنقضّ على المناسك والأديار وتعمل فيها القتل والنهب. فاضطر البار بمين مراراً أن يهرب مع أخوته أمام هجماتها، ويترك تلك الصحاري التي كان ينعم بخلواتها. ولكن لمّا كان السلام يعود فيخيّم على تلك الربوع، كان يعود إليها ليتابع فيها أعمال العبادة والصوم والصلاة وشغل الأيدي.
ولمّا شعر بدنوّ أجله، جعل غذاء حياته مناجاة الخالق بأنّات حب وشوق لا توصف. وكان جسمه الذي أضنته الأصوام والأسهار ينحلّ إنحلالاً. أمّا نفسه الملائكية، فإنّها كانت تذوب شوقاً إلى الإتّحاد الدائم بالله. ورقد بالرب سنة 451، مملوءاً فضيلة وأجوراً سماوية. وكان له من العمر ثمانون سنة، قضى خمساً وستين منها في القفر.
نياحة القديسة إيرينى (بحسب الكنيسة القبطية الارثوذكسية)
في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة أيريني (أي السلامة) كانت ابنة ملك وثني يدعي ليكينيوس. وكانت فريدة في جمالها الطبيعي، ولمحبة والدها لها بني لها قصرا حصينا وجعل معها ثلاث عشرة جارية لخدمتها، والسهر علي حراستها حفظا لها مما يفسد بهاء شرف عائلتها , وكان عمرها وقتئذ ست سنوات وقد ترك لها بعد التماثيل لتسجد لها وتعبدها وعين لها شيخا معلما حكيما لتعليمها. وحدث أن رأت القديسة في رؤيا حمامة وفي فمها ورقة زيتون نزلت ووضعتها علي المائدة أمامها ثم هبط نسر ومعه إكليل وضعه علي المائدة فجزعت من هذه الرؤيا وقصتها علي المعلم الذي كان مسيحيا دون أن يعرف والدها ذلك فأجابها: ان الحمامة هي تعليم الناموس وورقة الزيتون هي المعمودية والنسر هو الغلبة والإكليل هو مجد القديسين والغراب هو الملك والثعبان هو الاضطهاد وختم قوله بأنه لا بد لها أن تجاهد في سبيل الإيمان بالسيد المسيح
زارها أبوها ذات يوم وعرض عليها الزواج من أحد أولاد الأمراء فطلبت منه مهلة ثلاثة أيام لتفكر في الأمر. ولما تركها أبوها دخلت إلى التماثيل وطلبت منها أن ترشدها إلى ما فيه خيرها فلم تجبها فرفعت عينيها إلى السماء وقالت: يا اله المسيحيين أهدني إلى ما يرضيك". فظهر لها ملاك الرب وقال لها: سيأتيك غدا أحد تلاميذبولس الرسول ويعلمك ما يلزم ثم يعمدك " وفي الغد أتاها القديس تيموثاوس الرسول وعلمها أسرار الديانة وعمدها ولما علم أبوها بذلك استحضرها وإذ تحقق منها اعترافها بالسيد المسيح أمر بربطها في ذنب حصان جموع ثم أطلقه. غير أن الله حفظها فلم ينلها آذى. بل أن الحصان نفسه عاد وقبض بفمه علي ذراع والدها وطرحه علي الأرض فسقط ميتا. وبصلاة ابنته القديسة قام حيا وآمن هو وامرأته وثلاثة آلاف نفس ونالوا سر العماد المقدس وقد شرف الله هذه القديسة بصنع آيات كثيرة أمام ولاة وملوك حتى آمن بسببها كثيرون ولما أكملت جهادها تنيحت بسلام.
صلاتها تكون معنا. ولربنا المجد دائما. آمين.
وفي مثل هذا اليوم أيضاً : التذكار الشهري لوالدة الاله القديسة مريم العذراء
فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مرتمريم والدة الإله الكلمة أم الرحمة، الحنونة شفاعتها تكون معنا. آمين.